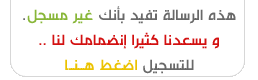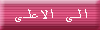في بيان مما يدل على صلاح القلب وفساده آية الله المشكيني
وليعلم أولاً : أن المقصد الأعلى والغرض الأسمى في هذا العلم السعي في إصلاح القلب وإكماله ، وتطهيره وتزكيته عن ذمائم الصفات ، وتزيينه وتحليته لفضائل السجايا وفواضل الملكات ، ليستعد على الاستفاضة من إنارة الألطاف الرحمانية وإضافة المعارف الالهية من حضرة ذي الجلال. فبالقلب شرف الإنسان وبه فضيلته على كثير من الخلق ، وبه ينال معرفة ربه التي هي في الدنيا شرفه وجماله ، وفي الآخرة مقامه وكماله. فالقلب هو العالم بالله ، والعامل لله ، والساعي إلى الله ، والمتقرب إلى جوار الله ، والجوارح أتباع وخدم يستعملها استعمال الملك للعبيد والصانع للآلة.
والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من الآفات ، والمحجوب عن الله تعالى إذا استغرق في الشهوات وهو الذي يفلح الإنسان إذا زكاه ويخيب ويشقى إذا دساه وهو المطيع لله على الحقيقة والمشرق على الجوارح أنواره وهو العاصي في الواقع والظاهر على الأعضاء آثاره وباستنارته وظلمته تظهر محاسن الظن ومساويه ، إذا كل إناء يترشح بما فيه.
وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه ، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه ، وإذا جهله جهل نفسه ، واذا جهل نفسه فقد جهل ربه.
وهو الذي جهله أكثر الناس وغفلوا عن عرفانه ، وحيل بينهم وبينه بمعاصيهم والحائل هو الله ، فإنه يحول بين المرء وقلبه ، وينسى الإنسان نفسه ويضله ولا يهديه. ولا يوفقه لمشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته ، فمعرفة القلب وأحواله وأوصافه أصل الأخلاق وأساس طريق الكمال.
والقلب لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالبدن شبه تعلق الأعراض بالأجسام ، أو تعلق المستعمل بالآلة ، أو المكين بالمكان.
والروح أيضاً عبارة عن هذه اللطيفة الربانية العالمة المدركة ، وهو أمر عجيب رباني يعجز العقول عن إدراك كنهه.
والنفس أيضاً هي اللطيفة المذكورة ، وهي الإنسان في الحقيقة ، وتتصف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها ، فإذا سكنت تحت أمر الله وزال عنها الاضطراب لثقتها بالله ولم تتزلزل ولم تضطرب ولم تنحرف عن سبيل الله وطريق الحق عند معارضة الشهوات سميت بـ « النفس المطمئنة ». وإذا لم يتم سكونها ولكن كانت مدافعة عن نفسها معارضة مع ما تقتضيه شهواتها سميت بـ « النفس اللوامة ». وإن أذعنت وأطاعت للشهوات ودواعي الهوى والشياطين سميت بـ « النفس الأمارة بالسوء ».
ثم إن طريق تسلط الشيطان على القلب : الحواس الخمس الظاهرة والقوى الباطنة : كالخيال والشهوة والغضب. فالقلب يتأثر دائماً من هذه الجهات ، وأخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر ، والخواطر هي المحركات للإرادات ، فإن سند الأفعال الخواطر ، والخاطر يحرك الرغبة ، والرغبة تحرك العزم والنية ، والنية هي الإرادة التي تحرك العضلات والأعضاء.
والخواطر المحركة قسمان :
1. قسم يدعوا إلى الخير ، وهو ما ينفع الإنسان في العاقبة .
2. قسم يدعوا إلى الشر وهو ما يضره في العاقبة ، والخاطر المحمود إلهام ، والمذموم وسوسة ، وسبب الخاطر الداعي إلى الخير في الغالب هو الملك ، وإلى الشر هو الشيطان.
والملك خلق من خلق الله ، شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالمعروف. والشيطان خلق على ضد ذلك. شأنه الوعد بالشر والأمر بالفحشاء ، والتخويف بالفقر عند الهم بالخير ، ولعل المقام من مصاديق قوله تعالى : ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) (1) فإن الموجودات متقابلة مزدوجة بمعان مختلفة. وقد ورد أنه للقلب لمتان : لمة من الملك ولمة من الشيطان ، واللمة : الخطوة والدنو والمساس. وورد أيضاً : إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان (2) ، أي : بين خلقين مقهورين بإرادة الله التكوينية كالإصبع من صاحبها وهما : الملك والشيطان ومعنى كونه بينهما أن الله يخلي بينه وبين أي منهما أراد حسب اقتضاء عمل الإنسان ورغبته ودعائه.
ثم إن القلب بأصل الفطرة صالح مستعد لقبول دعوات الملك والشيطان ويترجح أحدهما على الآخر باتباع الهوى والشهوات أو الإعراض عنها والميل إلى الطاعات ، فإن اتبع الإنسان مقتضى الأول تسلط عليه الشيطان وصار القلب عشاً له ، وصار صاحبه ممن باض الشيطان وفّرح في صدره ودب ودرج في حجره. وإن
1 ـ الذاريات : 51.
2 ـ المحجة البيضاء : ج5 ، ص 85 ـ بحار الانور : ج 70 ، ص 39 ـ مرآة العقول : ج 10 ، ص 394.
جاهد في مخالفة الشهوات كان قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم وعاد صاحبه ممن سبقت له من الله الحسنى ، وقد قال تعالى : ( وقل رب أعوذ من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) (1).
وذكرنا هذا ليسهل عليك فهم ما سوف نذكره من الأحاديث المقصودة واستفدنا ذلك من كلمات بعض المحققين على ما نقله عنه الفاضل المجلسي قدس سره في ج70 من البحار.
وأما النصوص الواردة في بيان القلب وحالاته فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد ، فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد ، وهي القلب » (2). والمراد بالقلب : الروح الإنساني التي لها تعلق خاص بالقلب الصنوبري ، والمراد من صحتها : حصول صفة التسليم لها ، ومن مرضها : عروض الطغيان عليها ، وسلامة سائر الجسد عدم صدور المعاصي منه ، وسقمه صدورها عنه. وهذا هو المراد من قوله عليه السلام : « إذا طاب قلب المرء طاب جسده ، وإذا خبث القلب خبث الجسد » (3). وكذا من قول علي عليه السلام : « أشد من مرض البدن مرض القلب ، وأفضل من صحة البدن تقوى القلوب » (4).
وفي صحيح أبان عن الصادق عليه السلام : « ما من مؤمن إلا لقلبه أذنان في جوفه : أذن ينفث فيها الوسواس الخناس ، وأذن ينفث فيها الملك ، فيؤيد الله المؤمن بالملك وذلك قوله : وأيدهم بروح منه » (5).
1 ـ المؤمنون : 97 ـ 98.
2 ـ بحار الأنوار : ج70 ، ص 50 ـ الخصال ص31.
3 ـ بحار الأنوار : ج70 ، ص50 ـ الخصال ص 31 ـ نور الثقلين : ج3 ، ص 585.
4 ـ بحار الأنوار : ج70 ، ص51.
5 ـ بحار الأنوار : ج63 ، ص194 ـ ج69 ، ص267 ـ ج70 ، ص48 ـ الكافي : ج 2 ، ص 267 ـ مرآة العقول : ج9 ، ص392 ـ نور الثقلين : ج5 ، ص269.
المصدر : دروس في الأخلاق - آية الله المشكيني
وليعلم أولاً : أن المقصد الأعلى والغرض الأسمى في هذا العلم السعي في إصلاح القلب وإكماله ، وتطهيره وتزكيته عن ذمائم الصفات ، وتزيينه وتحليته لفضائل السجايا وفواضل الملكات ، ليستعد على الاستفاضة من إنارة الألطاف الرحمانية وإضافة المعارف الالهية من حضرة ذي الجلال. فبالقلب شرف الإنسان وبه فضيلته على كثير من الخلق ، وبه ينال معرفة ربه التي هي في الدنيا شرفه وجماله ، وفي الآخرة مقامه وكماله. فالقلب هو العالم بالله ، والعامل لله ، والساعي إلى الله ، والمتقرب إلى جوار الله ، والجوارح أتباع وخدم يستعملها استعمال الملك للعبيد والصانع للآلة.
والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من الآفات ، والمحجوب عن الله تعالى إذا استغرق في الشهوات وهو الذي يفلح الإنسان إذا زكاه ويخيب ويشقى إذا دساه وهو المطيع لله على الحقيقة والمشرق على الجوارح أنواره وهو العاصي في الواقع والظاهر على الأعضاء آثاره وباستنارته وظلمته تظهر محاسن الظن ومساويه ، إذا كل إناء يترشح بما فيه.
وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه ، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه ، وإذا جهله جهل نفسه ، واذا جهل نفسه فقد جهل ربه.
وهو الذي جهله أكثر الناس وغفلوا عن عرفانه ، وحيل بينهم وبينه بمعاصيهم والحائل هو الله ، فإنه يحول بين المرء وقلبه ، وينسى الإنسان نفسه ويضله ولا يهديه. ولا يوفقه لمشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته ، فمعرفة القلب وأحواله وأوصافه أصل الأخلاق وأساس طريق الكمال.
والقلب لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالبدن شبه تعلق الأعراض بالأجسام ، أو تعلق المستعمل بالآلة ، أو المكين بالمكان.
والروح أيضاً عبارة عن هذه اللطيفة الربانية العالمة المدركة ، وهو أمر عجيب رباني يعجز العقول عن إدراك كنهه.
والنفس أيضاً هي اللطيفة المذكورة ، وهي الإنسان في الحقيقة ، وتتصف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها ، فإذا سكنت تحت أمر الله وزال عنها الاضطراب لثقتها بالله ولم تتزلزل ولم تضطرب ولم تنحرف عن سبيل الله وطريق الحق عند معارضة الشهوات سميت بـ « النفس المطمئنة ». وإذا لم يتم سكونها ولكن كانت مدافعة عن نفسها معارضة مع ما تقتضيه شهواتها سميت بـ « النفس اللوامة ». وإن أذعنت وأطاعت للشهوات ودواعي الهوى والشياطين سميت بـ « النفس الأمارة بالسوء ».
ثم إن طريق تسلط الشيطان على القلب : الحواس الخمس الظاهرة والقوى الباطنة : كالخيال والشهوة والغضب. فالقلب يتأثر دائماً من هذه الجهات ، وأخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر ، والخواطر هي المحركات للإرادات ، فإن سند الأفعال الخواطر ، والخاطر يحرك الرغبة ، والرغبة تحرك العزم والنية ، والنية هي الإرادة التي تحرك العضلات والأعضاء.
والخواطر المحركة قسمان :
1. قسم يدعوا إلى الخير ، وهو ما ينفع الإنسان في العاقبة .
2. قسم يدعوا إلى الشر وهو ما يضره في العاقبة ، والخاطر المحمود إلهام ، والمذموم وسوسة ، وسبب الخاطر الداعي إلى الخير في الغالب هو الملك ، وإلى الشر هو الشيطان.
والملك خلق من خلق الله ، شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالمعروف. والشيطان خلق على ضد ذلك. شأنه الوعد بالشر والأمر بالفحشاء ، والتخويف بالفقر عند الهم بالخير ، ولعل المقام من مصاديق قوله تعالى : ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) (1) فإن الموجودات متقابلة مزدوجة بمعان مختلفة. وقد ورد أنه للقلب لمتان : لمة من الملك ولمة من الشيطان ، واللمة : الخطوة والدنو والمساس. وورد أيضاً : إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان (2) ، أي : بين خلقين مقهورين بإرادة الله التكوينية كالإصبع من صاحبها وهما : الملك والشيطان ومعنى كونه بينهما أن الله يخلي بينه وبين أي منهما أراد حسب اقتضاء عمل الإنسان ورغبته ودعائه.
ثم إن القلب بأصل الفطرة صالح مستعد لقبول دعوات الملك والشيطان ويترجح أحدهما على الآخر باتباع الهوى والشهوات أو الإعراض عنها والميل إلى الطاعات ، فإن اتبع الإنسان مقتضى الأول تسلط عليه الشيطان وصار القلب عشاً له ، وصار صاحبه ممن باض الشيطان وفّرح في صدره ودب ودرج في حجره. وإن
1 ـ الذاريات : 51.
2 ـ المحجة البيضاء : ج5 ، ص 85 ـ بحار الانور : ج 70 ، ص 39 ـ مرآة العقول : ج 10 ، ص 394.
جاهد في مخالفة الشهوات كان قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم وعاد صاحبه ممن سبقت له من الله الحسنى ، وقد قال تعالى : ( وقل رب أعوذ من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) (1).
وذكرنا هذا ليسهل عليك فهم ما سوف نذكره من الأحاديث المقصودة واستفدنا ذلك من كلمات بعض المحققين على ما نقله عنه الفاضل المجلسي قدس سره في ج70 من البحار.
وأما النصوص الواردة في بيان القلب وحالاته فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد ، فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد ، وهي القلب » (2). والمراد بالقلب : الروح الإنساني التي لها تعلق خاص بالقلب الصنوبري ، والمراد من صحتها : حصول صفة التسليم لها ، ومن مرضها : عروض الطغيان عليها ، وسلامة سائر الجسد عدم صدور المعاصي منه ، وسقمه صدورها عنه. وهذا هو المراد من قوله عليه السلام : « إذا طاب قلب المرء طاب جسده ، وإذا خبث القلب خبث الجسد » (3). وكذا من قول علي عليه السلام : « أشد من مرض البدن مرض القلب ، وأفضل من صحة البدن تقوى القلوب » (4).
وفي صحيح أبان عن الصادق عليه السلام : « ما من مؤمن إلا لقلبه أذنان في جوفه : أذن ينفث فيها الوسواس الخناس ، وأذن ينفث فيها الملك ، فيؤيد الله المؤمن بالملك وذلك قوله : وأيدهم بروح منه » (5).
1 ـ المؤمنون : 97 ـ 98.
2 ـ بحار الأنوار : ج70 ، ص 50 ـ الخصال ص31.
3 ـ بحار الأنوار : ج70 ، ص50 ـ الخصال ص 31 ـ نور الثقلين : ج3 ، ص 585.
4 ـ بحار الأنوار : ج70 ، ص51.
5 ـ بحار الأنوار : ج63 ، ص194 ـ ج69 ، ص267 ـ ج70 ، ص48 ـ الكافي : ج 2 ، ص 267 ـ مرآة العقول : ج9 ، ص392 ـ نور الثقلين : ج5 ، ص269.
المصدر : دروس في الأخلاق - آية الله المشكيني